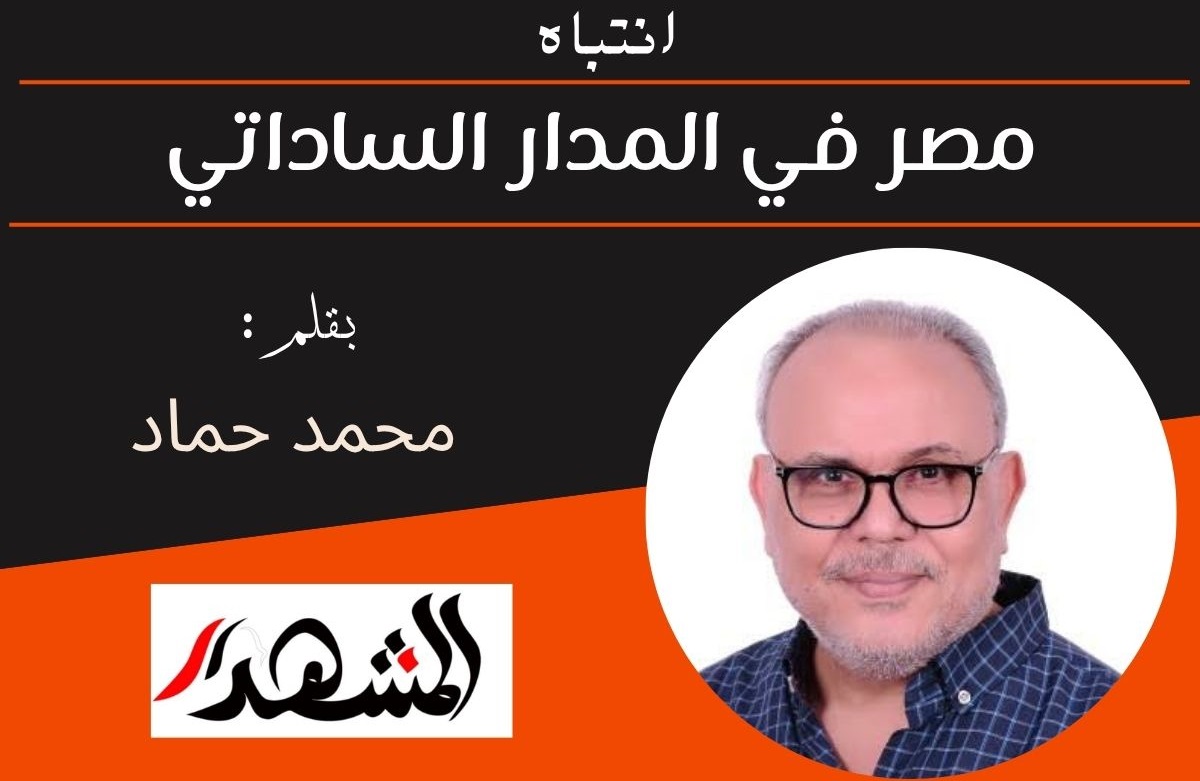مفارقةٌ لافتة أن جميع من جلسوا على كرسي الحكم في مصر بعد رحيل أنور السادات ساروا جميعًا على الطريق الذي شقّه، وأضاف كلٌّ منهم لمساته الخاصة عليه. لكن المفارقة الأعمق أن أحدًا منهم لم يفكر يومًا أن يجعل جمال عبد الناصر بوصلته، فظلّت حركة الدولة المصرية، رغم تغيّر الوجوه والظروف، تسير في الاتجاه ذاته الذي رسمه السادات، لا في الاتجاه الذي بشّر به عبد الناصرـ وحلمت به جماهير الأمة.
ترسّخت في بنية الدولة المصرية ساداتيةٌ بلا سادات؛ عقلٌ إداريٌّ يقدّم الواقعية على الحلم، والمصلحة على المبدأ، واللحظة على التاريخ. لم تعد الساداتية مجرد مرحلة في السياسة المصرية، بل أصبحت طريقتها الدائمة في التفكير وإدارة الواقع، فيما ظلّ المشروع الناصري حبيس الذاكرة، لا بوصفه تجربة حكم، بل كحلم مؤجّل عن وطنٍ أكبر من حدود الدولة، وأعمق من معادلات السوق والسياسة.
بعد رحيل عبد الناصر بدأت الساداتية محاولةً للهروب من ثقل المشروع الكبير إلى واقعيةٍ أكثر ضيقًا وأقل طموحًا. لكن ما بدأ كخيارٍ مؤقت تحوّل مع الزمن إلى منهج حياة؛ دخلت الساداتية في مفاصل الدولة والعقل العام، تسللت إلى البيروقراطية كما إلى الثقافة والإعلام، حتى باتت طريقة تفكيرٍ أكثر منها سياسة. صارت النظرة إلى العالم محكومة بمعادلات الربح والخسارة، وإلى الأمة باعتبارها جغرافيا لا رسالة.
لماذا السادات وليس عبد الناصر؟ ولماذا مضت الدولة في طريق الرجل الذي فكّك المشروع لا الذي بناه؟
الواقع أن مصر لم تختر الساداتية بإرادتها، بل فُرضت عليها فرضًا في لحظة ارتباكٍ تاريخيٍّ عقب رحيل عبد الناصر.
قاوم المجتمع المصري الساداتية في كل منعطف؛ بدءًا من انتفاضات الطلاب والعمال عامي 1972 و1973، وانتفاضة عمال حلوان 1975 وصولًا إلى الانتفاضة الكبرى في يناير 1977، لكن الدولة كانت قد حسمت وجهتها نحو واشنطن وتل ابيب، لا نحو الأمة والعروبة. وحين زار السادات القدس، كانت تلك لحظة القطيعة الكبرى: لم يكن الشعب معها بل عليها، ومع ذلك دخلت مصر طريق الصلح المنفرد، فوجدت نفسها مكبّلة باتفاقاتٍ قيدت إرادتها السياسية وصادرت قرارها الوطني. وهكذا، لم تنتصر الساداتية في الوعي المصري بقدر ما انتصرت في مؤسسات الدولة التي أعادت تشكيل وعيها على مقاسها.
لم تكن البنية النفسية للمجتمع المصري بعد رحيل عبد الناصر بنية هزيمة كما يُروَّج، بل كانت بنية استعدادٍ لمعركة جديدة. كان المزاج العام مشحونًا بعزيمة العبور واسترداد الأرض وإزالة آثار العدوان، وكانت الجامعات والمصانع تموج بروحٍ وطنية تُطالب بالحرب لا بالسلام، بالكرامة لا بالرضوخ.
تعاظمت الحركية الشعبية ضد الساداتية حتى وصلت الذروة في انتفاضة الخبز 1977 بينما كان السادات يبحث عن طريقٍ آخر، لا إلى سيناء بل إلى واشنطن. كانت أولى مبادراته السياسية في فبراير 1971 نسخةً طبق الأصل من مبادرة موشيه دايان، في وقتٍ كان الشارع يهتف للقتال لا للتفاوض.
في تلك المفارقة تأسست الساداتية: مشروع سلطةٍ يريد الخروج من المأزق بأي ثمن، في مواجهة مجتمعٍ يرى أن طريق الخلاص هو المواجهة لا التنازل. وهكذا بدأ الانفصال بين الدولة والأمة، بين من أرادوا عبور القناة بالسلاح، ومن أرادوا عبورها بالدبلوماسية المقيّدة بشروط العدو.
لم يكن الصراع في مصر بين تياراتٍ سياسية بقدر ما كان بين منطقين: منطق الدولة التي اختارت طريق التسوية والالتحاق بالمحور الأمريكي، ومنطق المجتمع الذي ظلّ يرى نفسه جزءًا من معركة الأمة ضد الاحتلال والتبعية.
ومع مرور الوقت، لم تهزم الدولةُ المجتمعَ بقدر ما استنزفته؛ أحكمت السيطرة على الإعلام والنقابات والجامعات، وروّضت المعارضة لتتحرك داخل الحدود المرسومة، حتى جرى فصل السياسة عن الناس، والوطن عن الأمة. ومن هنا بدأ التحوّل الأخطر: تحوّل الدولة المصرية من كيانٍ وطنيٍّ حاملٍ لطموحات الجماهير، إلى جهازٍ بيروقراطيٍّ يُدير الواقع كما هو، بلا مشروعٍ ولا حلم. استمرّت تلك القطيعة تتعمق جيلاً بعد جيل، فصارت الدولة تتحدث بلغة الإنجاز الإداري بينما يتحدث الناس بلغة الكرامة والعدالة. وهكذا ورث من بعد السادات دولةً منضبطة الشكل، لكنها خالية من المعنى.
أسّس السادات جمهوريته على شرعية النصر في أكتوبر 1973، لكنه استخدم هذه الشرعية في الاتجاه المعاكس لنتائج الحرب ذاتها. فبينما كانت الأمة تتطلّع إلى استكمال المعركة بتحريرٍ شامل واستقلالٍ حقيقي، راح هو يوظّف النصر لتبرير الانفتاح على الغرب، وفتح الأبواب لسياساتٍ اقتصادية واجتماعية غيّرت وجه مصر وطبقتها الوسطى معًا.
كانت تلك هي البداية الحقيقية للجمهورية الساداتية: جمهوريةٌ قامت على تحويل نصر السلاح إلى سلامٍ بالشروط الأمريكية، وعلى نقل مركز القرار من القاهرة إلى واشنطن، ومن المصلحة الوطنية إلى معادلات السوق والارتباطات الخارجية. ومن هنا نشأت طبقةٌ جديدة حارسة لهذا التحوّل، وُلدت من رحم الانفتاح، وارتبطت مصالحها بالمعونة والعلاقات الخاصة مع الولايات المتحدة وإسرائيل. لم تكن الجمهورية الساداتية نظامًا فحسب، بل شبكة مصالح متشابكة جعلت استمرارها ضمانًا لبقاء أصحابها، فتحولت من مشروع رجل إلى واقع دولة.
وحين جاء حسني مبارك إلى الحكم، لم يأتِ بمشروعٍ جديد، بل بوراثةٍ دقيقة للجمهورية التي شيّدها السادات. تولّى السلطة باسم "الاستقرار"، فكان دوره أن يُجمّد الحركة في الاتجاه الذي رُسم من قبله: الحفاظ على معاهدة السلام، واستمرار العلاقة الخاصة مع واشنطن، وإدارة الاقتصاد بذات فلسفة الانفتاح التي فتحت الباب واسعًا أمام الفساد والطبقات الطفيلية.
في عهده ترسّخت البيروقراطية الحارسة للنظام، وتحوّل الحكم إلى إدارةٍ للأمن لا إدارةٍ للوطن. تآكل المجال العام، وذبلت السياسة، وأُفرغت الأحزاب من مضمونها، بينما أُعيد إنتاج الساداتية في شكلٍ أكثر هدوءًا وأقل مغامرة، لكنها أشد رسوخًا.
كان مبارك هو حارس الجمود الكبير: لا يتقدّم إلى الأمام، ولا يسمح بالعودة إلى الوراء، يكتفي بأن يُبقي السفينة واقفة على سطح الماء، ولو كانت قد فقدت اتجاهها. وهكذا امتدّت الجمهورية الساداتية ثلاثة عقودٍ كاملة في ثوبٍ جديد، محميةً بشبكة المصالح ذاتها، ومحكومةً بالذهنية التي ترى في التغيير خطرًا، وفي الرضا بالواقع حكمة.
وعندما اندلعت ثورة يناير 2011، بدا أن الباب الذي أُغلق منذ السبعينيات قد انفتح أخيرًا، وأن مصر تستعيد حقّها في الحلم والتغيير. لم تكن يناير ثورة على شخصٍ بعينه، بل على منطقٍ كامل حكم الدولة والمجتمع منذ السادات؛ منطق إدارة بلا رؤية، واستقرار بلا عدالة، وواقعٍ بلا مشروع. كانت صيحات الميادين تطلب ما غاب لعقود: الكرامة، والعدالة، والحرية، أي العودة إلى جوهر المشروع الوطني الذي انقطع خيطه منذ أكتوبر.
لكن النظام الذي تصدّع في الواجهة لم يسقط في الجوهر، لأن بنية الجمهورية الساداتية كانت أعمق من رأسها. انهار الشكل، لكن بقيت الشبكة التي نسجتها أربعون سنة من المصالح والولاءات والعلاقات المتشابكة.
حاولت مصر أن تخرج من المدار الساداتي، لكن قوى الداخل التي استفادت من بقاء النظام، وقوى الخارج التي رأت في استمراره ضمانًا لمصالحها، تعاونت على إعادة البناء من جديد، بنفس الطوب، على نفس الأسس.
بعد عام 2013 عادت الساداتية إلى المسرح، استعاد النظام الجديد جوهر فلسفة السادات دون الحاجة إلى أي غطاءٍ أيديولوجي أو تبريرٍ سياسي: تحالفٌ صريح مع واشنطن وتل أبيب، وانفتاحٌ اقتصادي بلا ضوابط اجتماعية، وتضييقٌ على المجال العام باسم الاستقرار، مع إعادة هندسة الوعي والإعلام لتكريس فكرة أن المصلحة تسبق المبدأ، وأن الأمن أهم من الحرية، وأن الوطنية هي الطاعة لا المشاركة.
تحوّلت الدولة إلى جهازٍ ضخم يتحرك وفق حسابات اللحظة، لا وفق رؤية التاريخ. ولأول مرة بدا أن مصر تعيش «ساداتية بلا سادات»، حيث غاب الوجه وبقيت البصمة، وغابت السياسة وبقيت السلطة، وغاب المشروع وبقي النظام. كانت تلك ذروة اكتمال المسار الذي بدأ عام 1971: دولةٌ اختارت أن تُدار من الخارج إلى الداخل، وأن تُقاس قوتها بما تملكه من استقرارٍ لا بما تملكه من معنى.
إن تجاوز المدار الساداتي لا يكون بإنكار ما جرى، بل بفهمه: أن نقرأ تجربة التحوّل من المشروع إلى السوق، من الأمة إلى الفرد، من الفكرة إلى الصفقة، لا بوصفها «خيانة مشروع» فقط، بل كتحوّلٍ عميق في بنية الوعي المصري نفسه. وما لم يُستعاد هذا الوعي إلى توازنه، سيظل المستقبل نسخة باهتة من الماضي.
وهذا موضوع حديث آخر. (كيف يخرج العقل المصري من المدار الساداتي)
--------------------------------------------
بقلم: محمد حماد